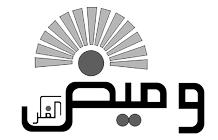- المقدمة:
تعتبر الزراعة رافعة مهمة للاقتصاد وتطوير المجتمعات وصلابة تماسكها، فالأمن الغذائي هو الركيزة الأولى في التطوير الحضاري لأي مجتمع من المجتمعات البشرية.
من هنا أردت أن أطرح الأسئلة التالية والتي تعتبر إشكالية هذا البحث وهي:
- هل ترك العرب المسلمون بصمات حضارية مهمة في مجال علم الزراعة والري ؟؟؟
- هل كانت طبيعة الأندلس مناسبة لتفتق أفكار العرب وابداعاتهم في تنظيم إرواء أكبر مساحة ممكنة من أرضها والاستفادة منها؟؟ وما هي أهم التقنيات التي استعملها العرب المسلمون في ذلك الوقت؟؟
- وهل حدد المسلمون في الأندلس الإطار التشريعي لاقتسام الثروة المائية وحل النزاعات حولها بالشكل النموذجي العادل؟؟
- من هم أبرز العلماء اللذين لمع اسمهم في مجال علم الزراعة والري في الأندلس؟؟ وماذا تركوا لنا من تراث حضاري ومؤلفات ؟؟؟؟
كان من دأب المسلمين إذا فتحوا أي بلد، بدأوا بشيئين مهمين جداً هما بناء المسجد وإقامة المشاريع الزراعية([1])، فقد كان هم الولاة الأول بعد العبادة تأمين الاستقرار الاقتصادي القائم بالدرجة الأولى على الزراعة، وذلك حسب أوامر شرعية، فالله تعالى أمر البشر بالسعي والتنقيب في الأرض، لإخراج ما فيها من خيرات إن عن طريق الزراعة أو غيرها. لذلك كله أخد علم الفلاحة في المجتمع الاسلامي من العناية الشيء الكثير، وكانت الزراعة تزدهر في عهد الدول التي تعمل على توفير مياه الري واستصلاح الأراضي وتيسير نقل المحاصيل.
من هنا عمد المسلمون في الأندلس إلى إصلاح وسائل الري وتنظيمها وبناء السدود وحصر القنوات وإقامة الجسور والقناطر([2])، واستغلوا الأراضي الزراعية باستنبات النبات المناسب في التربة الصالحة لها، بعد ان وقفوا على خصائص أنواع التربة. وابتدعوا تقنيات في الري ونظموا الاستفادة من الثروة المائية.
وقد نبغ في علوم الزراعة والري علماء كثر، وكتبوا رسائل وأسسو مدارس ما زالت معتمدة حتى يومنا الحاضر. فالإبداع العلمي في الزراعة يعتبر حجر الزاوية الذي حقق للانسانية إنجازين في غاية الأهمية الأول هو توفير المزيد من الغذاء الذي يفوق حاجة المزارع، والإنجاز الثاني هو ما يترتب على وفرة الغذاء، من منح فرصة للبشر، للالتفاف إلى إبداعات علمية أخرى في مجالات غير زراعية، تؤدي إلى صناعة حضارة إنسانية. وكان من أهم هذه الإبتكارات عدد من النماذج الحضارية التي تضم أنظمة حديثة وتقنيات فريدة استخدمها المسلمون في الأندلس لإدارة الموارد المائية في ذلك العصر.
- أنظمة وتقنيات الزراعة والري في الأندلس
في الثمانينات من القرن العشرين تضافرت مجموعة من الظروف المتزامنة، لتحفيز فيضاً من الدراسات التاريخية الجديدة عن الزراعة والري في إسبانيا، منها تركز على الفترة الاسلامية والإسهام الاسلامي، من هذه الحوافز نذكر:
- نظام الحكم الذاتي في أسبانيا (Regimen de autonomias) الذي حفز ومول عدداً كبيراً من الدراسات ذات النوعية العالية في التاريخ المحلي .
- تلاشي الاجماع القديم للقروسطية الإسبانية التي ركزت على زراعة الحبوب كأساس للزراعة([3]).
ومن هنا فقد اعتقد أميريكو كاسترو (Americo costro)([4]) أن ثمة منعطفاً ثقافياً اجتماعياً حاداً قد نجم عن الفتح العربي، وقد ناقش الكثير من المتخصصين بدراسة القرون الوسطى بأن تثاقف المولدين(أي التبادل الثقافي بينهم) كان كاملاً وأن ثقافتهم يجب أن تدعى “اندلسية“([5]).
ففي الاندلس تنوعت مصادر مياه الري منها مصادر المياه السطحية ومنها الجوفية، وفي هذا البحث سنتحدث عن الادوات المستخدمة في الري حيث استطاع العرب هناك تأسيس قاعدة علمية تكنولوجية قوية لأنظمة الري التي أصبحت لاحقاً منهلاً للحضارات العالمية الأخرى وبخاصة الحضارة الأوربية الزراعية التي استمدت كثيراً من مقوماتها من نتاج الحضارة العربية الاسلامية ولا تزال تعمل بهذه الأنظمة حتى يومنا هذا.
ولقد درس زراعيو الاندلس المسلمة تركيب التربة، وسعوا جهدهم في استصلاح الأراضي البور، كما حاولوا تحديد خواص الأسمدة وملاءمتها بحسب الحالات وأعادوا تصنيفاً للمياه، ودرسوا وسائل استثمارها بواسطة القنوات والآبار والنواعير وسواها من الوسائط، وكانت مكائنهم والعجلات البدائية لديهم، قد ألهمت علماء الميكانيك(كالمرادي) وساعدتهم على التقدم في صناعة آلاتهم الميكانيكية التي تحولت الى ساعات فيما بعد([6]).
ففي ظل الرعاية الاسلامية، سجلت الزراعة في إسبانيا تقدماً ملحوظاً على باقي الغرب، فقد نقل العرب العادات الزراعية من أسيا وشقوا قنوات الري وأدخلوا زراعة الكرمة والحنطة السوداء والزيتون في الجنوب وزراعة اشجار النخيل، وزراعة التوت لتربية دود القز، وقصب السكر والارز والهليون والسبانخ وكميات من الفواكه التي لم تكن معروفة هناك مثل: الرمان والبرتقال والسفرجل والغريفون والدراق والتين والليمون الحامض والمشمش، عندها بلغت قرطبة وغرناطة وسهول فالنسيا وموريس الخصبة مبلغاً كبيراً من الشهرة العالمية في المكان والزمان، ولا ريب أن جنائن هذه المناطق المميزة لا تزال اليوم ذات طابع عربي مغربي، وأن ذلك النمو الرائع للزراعة هو أحد المكاسب المستديمة التي تدين بها إسبانيا للحضارة العربية([7]).
لقد بذل الأندلسيون جهوداً كبيرة في اقامة مشاريع الري مثل بناء السدود والقناطر والجسور وحفر القنوات السطحية والجوفية لتسهيل وصول المياه الى الاراضي الزراعية. وباستحضار البعد التقني فقد عرفت الأندلس ثلاثة انواع من أنظمة الري وتقنيات السقي، بالإضافة الى معجزة جر المياه إلى قصر الحمراء في غرناطة وهي:
أولاً: نظام الري الكبير :
هو النظام الذي يكتسب مقوماته من ضرورة توافر جملة من الأسس تميزه عن غيره من الأنظمة، وعلى رأسها اتساع المساحة الزراعيةووفرة المياه المستمدة من الأحواض النهرية، وشبكات توزيع مدعمة بتجهيزات تقنية فعالة، ومناخ قانوني تغلب فيه الحيازة على الملكية، وإطار تنظيمي يشرف على تدبير شؤون الري وقلة النزاعات على الماء. وكل هذه المعايير توافرت في الأندلس في عدد من المناطق وخاصة بأحواز غرناطة، التي تعد أنموذجا لتوافر المعايير المحددة للدوائر السقوية الكبيرة وانسجامها. وقد كان للعرب السبق في استعمال هذا النظام في الأندلس، فان الثلث الشرقي من السهل الغربي الجنوبي لنهر الميخارس(Mijares) غني بأسماء الأماكن العربية حيث كان بؤرة الوجود الاسلامي، اذ وصفه الجغرافي الإدريسي بأنه منطقة مزدهرة وكثيرة المياه.
والجدير ذكره هنا، أن من بين القنوات الرئيسية وفروعها كان النصف تقريباً يحمل أسماء عربية بما في ذلك قناة مسلاتا (منزل عطاء) وفافارا (Favara)([8])، وراسكانيا(Rascanya) (وتعنى راس الفتاة )، وفيتانار(Fitanar) ( تعنى خيط النهر) وهي ترجمة عربية حرفية، وبناتجر(Benatger) (نسبة الى فخذ من قبيلة) وقناة الجيروس(Algiros) (من الزروب وتعني القنوات) وهكذا دواليك([9]). وكانت القنوات التي تحمل أسماء عربية تشكل شبكة متماسكة، بينما كانت الأخرى غير العربية متناثرة النمط. كان يوجد أيضاً تمديدات بناها المسلمون في الحد الخارجي من منطقة أقصى جنوب لورقة([10]).
ومن ذلك نستنتج أن تكثيف نظام الري الذي بناه المسلمون مَحَقَ شبكة القنوات الأقل شأنا بكثير والتي صادفوها هناك، وأن الشواهد والأدلة المتعلقة بالآثار وأسماء المواقع تشير إلى أن المسلمين استولوا على أرض كانت تروى باعتدال وتواضع، فاعادوا بناء أنظمة ري حديثة ووسعوها كما أنهم أعادوا تنظيم إجراءات التوزيع والإدارة وفقاً للقواعد التي كانوا يحملونها([11]).
كما أثبتت الطبيعة العربية لنظام الري الخاص بأراضي الري البلنسية، استنادا إلى التشابه في ترتيبات التوزيع هناك مع تلك الموجودة على نهر بردى في غوطة دمشق. ففي كل حاله يعتقد بأن ماء النهر يحمل 24 وحدة من الماء في كل مرحلة من مراحل انعطافه، ففي دمشق تسمى تلك الوحدات (قراريط)، وفي بلنسية (فيلات)(Filat)([12]).فالعرب المسلمون الذين قطنوا الأندلس لم يحضروا معهم القنوات أو السدود أو النواعير بل أحضروا معهم الأفكار الخاصة بذلك فقط. لذا فإنه عند تقسيم التكنولوجيا الهيدرولية في الأندلس فإن المصدر المادي المتعلق بالقنوات ليست له صلة بالموضوع. فأي شي وجده المسلمون دمجوه في نظام اجتماعي وثقافي واقتصادي يختلف تماما عما كان سائداً من قبل، وذلك وفقاً لقواعد سلوكية أحضروها معهم. لذا فإن وجود إنسان عربي واحد في تلك المنطقة يعرف نظام الري في بلاد الشام، كان يكفي بأن يدخل ذلك النظام إلى البلاد الأندلسية([13]).
ثانياً:أنظمة الري المتوسطة:
ساد هذا النظام في المجالات السقوية التي تغلب فيها النسبة العقارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وضعف فعالية التقنيات وتداخل الحقوق المائية ومحدودية دور السلطة في تدبير الري، بالإضافة إلى وضعية عقارية شديدة التعقيد تؤدي في أحيان كثيرة إلى النزاع والخصومة على الماء.
وتعد الآبار والعيون أهم المصادر المائية بالنسبة لقطاعي الري المتوسط والصغير، اما السقي فيعتمد على مجموعة من التقنيات البسيطة من حيث التركيب كان منها طواحين الماء، والنواعير([14]) الشبيهة إلى حد بعيد بما كان منتشراً في بلاد المشرق. وهذا الأمر من شأنه أن يكشف لنا عن الأصل الحضاري للري في الأندلس. حيث كان هناك نظامان للري : الأول يتالف من ينبوع وخزانين للمياه وقنوات، كانت تروى نحو تسع هكتارات، أما النظام الثاني فقد كان نظاماً واضح المعالم يروي حوالي خمسة هكتارات مع عين ماء يخزن ماؤها في سد تخزين، ثم يوزع في وحدات زمنية تقاس بواسطة ساعة مائية. وهذا النظام كان يتطلب أن يرفع الماء إلى بعض الحقول، وقد وجدت هناك آثار شادوف([15]) وناعورة ما زالت باقية هناك. ومن هنا نستخلص أن تكنولوجيا الرفع والتخزين في سلسلة الجبال بشكل خاص، وفي مناطق الري البلنسية بشكل عام، كانت تكشف عن التمازج بين الجذور الاسلامية والكلاسيكية. وأن تقديم دولاب المياه المدار بواسطة الحيوانات يشير إلى كفاية أعظم وكان لا بد من أن يسهل التكثيف الاسلامي للزراعة في المناطق التي لم تكن مروية من قبل المسلمين.
ونلاحظ أن نظاماً متوسطاً أكبر في هذه الحالة لا بد أن يكون من تقديم عربي دون أدنى شك، وقد وجدناه في عدة مناطق كان منها بني البوفار وفي ميروقة، فهذه المنطقة التي تبلغ مساحتها ستين هكتاراً، كانت تروى بواسطة قناة ثم توزع المياه على خزانات او صهاريج([16]) ذات نوعين الأول كان مكشوف والثاني كان مغطى، ومن هذه الخزانات والصهاريج كانت تروى الحقول المدرجة في نوبات اسبوعية، والحقول كانت تطوق بمدرجات تسمى (Marjades) لأن كلمة (murqa) كانت تعني الجدار المساند. ويعتقد أن المصطلحات كانت مشتقة من الكلمة العربية “مَعجِل” وأنها ادخلت جنباً إلى جنب مع الذخيرة المرافقة من التقنيات الهيدرولية، من جنوب الجزيرة العربية في أواخر القرن السادس الهجري/الثاني عشر ميلادي، ولقد وجدت تقنية القناة أو سراديب الترشيح (التنقية) الفارسية منتشرة بشكل واسع في إسبانيا الاسلامية وفي أنظمة الري المتوسطة المستوى. وكانت توصف القنوات أحيانا بأنها آبار عمودية، ولكن سراديب الترشيح الصحيح إنما يبنى ليكشط سطح الماء ويكون مزوداً بمحاور عامودية لتزويد عاملي الصيانة في الأنفاق بالمنفذ والهواء وهنا يلاحظ أن العرب استخدموا تشكيلة من التقنيات ذات العلاقة لنقل المياه تحت سطح الأرض، خصوصا في الأراضي الصعبة التي لم تكن كلها تقبل المياه بالترشيح كما أنهم بنوا سراديب ترشيح في أحواض الأنهار، التي تعد تضاريس أو طبوغرافية مميزة للقنوات([17]).
كما ابتكر الفلاحون الاندلسيون نظام القنوات الجوفية للمياه حيث تحكموا بجريان الماء فيها بطرق هندسية بديعة حيث يتم إيصالها من المناطق المنخفضة إلى المناطق المرتفعة دون استخدام الروافع وتتم هذه الطريقة بحفر عدد من الآبار والتوصيل بينهما ثم توصيل هذه الابار بمجارٍ جوفية عميقة من الطوب الأحمر وتكون واسعة ومرتفعة بحيث تستوعب قامة الانسان وفي قاع هذه المجاري تمتد القنوات المصنوعة من الفخار لتنقل الماء من الآبار ويجب أن تكون على انحدار خفيف ومتجهة نحو المدينة.
وعادة ما تسمى القناة المحفورة في الأرض والتي تجري فيها المياه بـ(الكظمية ) وجمعها كظائم([18])، أما القنوات المصنوعة من أنابيب من الرصاص والتي يتم بواسطتها استخراج مياه الآبار الفوارة إلى سطح البئر تسمى بـ(كهاريز)([19])، وفضلاً عن القنوات المائية الجوفية هناك القنوات المائية السطحية التي كانت تصل إلى المزارع والمدن والأرياف في الأندلس، وكانت القنوات تستخدم في المدن حيث كان العمال الذين يصنعون القنوات ويصلحونها يؤلفون جماعة هامة. أما في خارج المدن فإن السقائين هم الذين يمونون الناس بالمياه فكانوا يبيعون للبيوت ماء النهر القريب من المدينة. ولقد تفوق العرب المسلمون في الأندلس على الرومان في هذا المجال وبذلوا جهوداً كثيرة من أجل إيصال المياه عبر قنواتهم إلى مزارعهم وحدائقهم وبيوتهم([20]).انتشرت العديد من القنوات في الاندلس، فقد أنشأ الأمير عبد الرحمن الداخل(113–172هـ/731–788م) قناة تمد البلد بالمياه الجارية([21])، والقناة التي بناها عبد الرحمن الناصر(277هـ-355هـ/891م-961م)، وكان ذلك في صدر سنة (329هـ/940م) وكانت ” قناة غريبة الصنعة حيث أجرى إليها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة وفي المناهر المهندسة وعلى المنايا المعقودة يجري ماؤها بتدبير عجيب وصنعة غريبة محكمة إلى بركة عظيمة، عليها أسد عظيم الصورة، بديع الصنعة، شديد الروعة لم يشاهد أوفى منه ولا أبهى منه فيما صور الملوك في غابر الدهر مطلي بذهب أبريز وعيناه جوهرتان، لها وميض شديد يمج الماء من فمه في تلك البركة فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره ، فتسقى منه جنان هذا القصر على سعتها ويستفيض على ساحاته وجنباته ويمد النهر الأعظم بما فضل منه، فكانت هذه القناة وبركتها. والتمثال الذهب الذي يصب فيها من أعظم آثار الملوك في غابر الدهر لبعد مسافاتها واختلاف مسالكها وفخامة بنيانها وسمو أبراجها التي يترقى الماء فيها ويتصوب من أعاليها وكانت مدة العمل فيها أربعة عشر شهراً([22]). وقد أودع الخليفة الحكم المستنصر(302–366هـ/915–976م) جوف هذه القناة أنابيب الرصاص لتحفظه من كل دنس([23])، فضلاً عن وكان هناك قنوات أخرى في مناطق مختلفة في الأندلس مثل مدينة لاردة التي عرفت بقنواتها الرائعة الصنعة التي ساعدت على ازدهار الزراعة فيها، وفي مدينة بربشتر قنوات محكمة الصنع تسقى من عين هناك. كما استخدمت القنوات وبشكل كبير داخل المدن بهيئة شبكة من القنوات الجوفية لتوزيع المياه على أحيائها وتوصيلها بطريقة فنية إلى مختلف مرافقها، وفي مدينة استجة أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر ببناء قناة مياه للري، كما أمر ابنه الخليفة الحكم المستنصر ببناء قنوات عديدة لري غرناطة ومرسية وبلنسيه وأرغون. كما بنيت العديد من القنوات في مدينة لورقة التي أفادت منها المنطقة في الري والزراعة([24])، كما بنيت قناة في مدينة أونبة([25])، لجلب المياه إليها وكانـت هـذه القنـاة مخترقة الجبال الشامخة بحيث تصل هذه المياه إلى أسفل المدينة فتسقي بساتينها وقنوات أخرى في مدينة طركونة ([26]).التي كانت تأتيها المياه عن طريق هذه القنوات المشهورة بها هذه المنطقة. كما برع الأندلسيون ببناء سدود التحويل التي تنشأ عبر الجداول لتحويل مياهها الى القناة([27]).
ثالثاً: انظمة الري الصغيرة :
إن تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها في سلسلة جبال إسبادان(Sirra de Espadan) هي أنظمة صغيرة تماماً: قرى تروى عن طريق ينبوع او ينبوعين مع حشد كثيف من التقنيات الهيدرولية المقرونة إلى حد بعيد بالوجود العربي هناك، حيث كانت تحتوي على حقول مدرجة وخزانات المياه والشادوفات والنواعير وكان القياس بواسطة الساعات المائية. وسنعرض هنا بعض الأمثلة لأكثر أنماط الري في أنظمة الري الصغيرة والتي كانت معروفة في الأندلس في ذلك الوقت وهي:
- النواعير: كانت أكثر أنماط الري الصغيرة شيوعاً إلى حدٍ بعيد مزرعة الأسرة الواحدة المروية بواسطة ناعورة تشغل بقدرة الحيوان([28]). وكان الدولاب الأكبر حجماً والذي يديره التيار، والذي يرفع الماء بواسطة إطار خارجي مجزأ بدل من سلسلة من الأوعية، ويرفع كمية كبيرة من الماء، وهو يمثل واحدة من سمات أنظمة الري الكبيرة أو المتوسطة حيث توجد على الجداول الدائمة الجريان أو الأنهار أو كما في مناطق الري التي في مرسية، على قنوات الري الرئيسية والدولاب الذي يديره التيار يمكن تحويله إلى عمودية تدور بالدفع السفلي بكل بساطة عن طريق وصله بمحور أفقي. وهكذا فان هاتين التقنيتين وثيقتا الصلة، والصانع واحد لأن من يستطيع صنع الدولاب يستطيع صنع الرحى العمودية([29]).
ذكر ابن العوام وأبو الخير مواصفات عن بزل الآبار في الأندلس وعن بناء النواعير، ورغم انتشار هذه النواعير في كثير من الأماكن إلا أنها لم تحض بدراسة كبيرة وقد اختفت الأن عمليا في اسبانيا، لذلك فقد اقتصرت المعلومات عنها في علمي الآثار والهندسة، وأن مسحاً أثرياً حديثاً حدث في منطقة بياكانياس (Villacanas) في لامانشا(La Mancha) أي في طليطلة الاسلامية، حيث كانت النواعير منتشرة بكثافة وقد كشف عن كثير من آبار النواعير المزودة بسلالم أو أنفاق تؤدي إلى سطح الماء([30]). وهذه التقنية تتعلق بتلك الخاصة بشق الأنفاق للقنوات. وفي الحقيقة كما يوحي بذلك اسمها، كان هناك أيضا قناة في بياكانياس وكانت تدعى “النقب” بالعربية الاندلسية، كما في عبارة “نقب البئر” وعلى هذا الأساس فإنه يرى أن الأصل التاريخي لإسم منطقة (Mancofar) وهو “المنقوبة” أي بئر مع سرداب … يعنى قناة وكان يشق للآبار أنفاق ليس فقط أفقياً، كما في القنوات بل عمودياً أيضا وكذلك بشكل منحرف كما في سلم المدخل للناعورة. ومن الملاحظ هنا أن استخدام النواعير المدارة بواسطة الحيوانات على نطاق واسع جعل من الممكن لمزرعة العائلة ان تنتج فائضا للسوق. لذلك فان “ثورة النواعير” كانت مرتبطة بشكل اساسي مع التوسع في الاقتصادات الاقليمية التي تميز بها عصر الطوائف.
وكشفت الحفريات مؤخراً في منطقة أوليفة (Oliva) (الزيتونة) (عند مدينة بلنسية) عن موقع لناعورة كان يستخدم بشكل متواصل منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي([31]) حتى منتصف القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي وأن أكثر ما يبعث على الاهتمام بهذا الموقع أنه كان ينتج أكثر من خمسة آلاف قطعة من أواني الناعورة التي كانت تعرف بالإسبانية باسم (arcaduz)، ومن العربية “قادوس”… وهذا ما يبين لنا أولاً أن التنقيب الذي أوصى به ابن العوام كطريقة لمنع الانكسار الناتج عن اصطدام الوعاء بسطح الماء، والذي كان قد عرف قبل نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وثانياً أن شكل هذه الأواني يذكرنا بالطراز المتبع في بلاد الشام. ويمكنني أيضا أن أضيف أنه في تلك المناطق من إسبانيا التي استخدمت فيها النواعير، فإن اواني الناعورة التي كانت مطلوبة بأعداد ضخمة كقطع بديلة كانت الأساس في صناعة الفخار المحلية.
- الطواحين المائية: كانت الأندلس تحتوي على عدد وافر من الطواحين المائية. فسجل بالنسية مثلا كان يذكر أكثر من مئة طاحون، خمسة وثلاثون منها في المدينة نفسها (مناطق الري التابعة لها)، وتسعة عشر في شاطبة. وهذه كانت طواحين أفقية، كان كثير منها بأكثر من حجر رحى واحد ( وهذا دليل على وفرة الطاقة الهيدرولية المتاحة في الأنهار وقنوات الري) كما أن كثيراً منها كان مملوكاً لكبار المسؤلين (كالرئيس والقائد) وفي شاطبة كان هناك طاحونتان مسجلتان على ان ملكيتهما تعود الى الدولة “المقسم”(Almacazem) ويفترض ان جميع هذه الطواحين هي طواحين حبوب أفقية، أولاً: لأنه لم يخصص هناك أي طواحين صناعية التي كانت عمودية بشكل عام وثانيا: لأنه لم يكن في بلنسية أي موقع طواحين مزود ببركة ماء لإدارة دولاب الطواحين بالدفع العلوي، التي تحتاجها الطواحين العمودية وهذا الأمر لا يستثني الطواحين العمودية التي تسير بالدفع السفلي التي تنطوي على تكيف بسيط للدولاب الذي يدار بالتيار، ولكن أيا منها غير موثق بوضوح، فقد يكون من الممكن تبني الطواحين الافقية لاغراض صناعية بسيطة. ويذكر القرزويني طاحونة أفقية في ميروقة كانت في اوقات شح الماء توصل بدولاب ناعورة وتشغل كطاحونة عامودية تسير بالدفع العلوي وتغذي بواسطة شلال. ومما لا شك فيه انه كان ثمة ترابط بين انتشار الطواحين وأنظمة الري حيث ان الطاحونة في الاندلس كانت استدراكا للري وتابعة له، فالطواحين وقنوات الري سواء بسواء تقنيات شبه عالمية ([32])، وأن هذه التقنيات هي عبارة عن ابداعات بشرية يمكن بمظهرها الميكانيكي أن تحلل وتصنف دون الرجوع إلى الثقافة المحيطة بها، ولكن التكنولوجيات، أي التقنيات بصفتها أنظمة معرفية خاصة بمجتمعات وثقافات معينة، والأندلس تنتصب على طرفي أوروبا وأسيا من الناحية الجغرافية وتمتد بين إسبانيا الرومانية وإسبانيا الحديثة من ناحية تاريخية، إلا أن أنماط الانتشار والاختراع والابتكار التي يكشفها التاريخ وعلم الأثار يجب أن تفسر على أساس ما نعرفه من النظام الاجتماعي في المجتمع الأندلسي، ونظراً لأن المجتمع الأندلسي الزراعي لا يمكن معرفته إلا من خلال آثاره ومن خلال التحليل المقارن.
- الري بالعيون: عرفت الأندلس العربية أيضاً الري بالعيون: حيث زود إقليم سرقسطة في الأندلس بالمياه وفق تنظيم دقيق حيث يوجد في هذا الاقليم “عين تنبعث بماء غزير له محبس إذا أراد أهله أن يفتحوه فتح وإذا أحبوا حبسه حُبس فلم يجر”. والحبس هو المنع([33]) . وهو كذلك خشبة أو حجارة تستعمل لسد مجرى الماء وجمعها أحباس([34]). وقد قام بتدبيره الأول (الأقوام السابقة) على هذا وأجروه في صخر منقوب يوثق فيه ويطلق منه وهو على بعد ثلاثين ميلاً من مدينة سرقسطة.
- الري بالتنقيط: كان قد عرفه العرب في الأندلس: وهي طريقة لسقي الأشجار بكميات قليلة جداً من الماء ولكنها كافية لنموها وتتمثل هذه الطريقة بوضع جرة أو جرتين من الفخار قرب جذور الشجرة ملئتا بالماء ويبدأ الماء بالنزول تدريجياً ليغذي هذه الشجرة لمدة شهرين في فصل الجفاف. وهذا يؤدي إلى توفير مياه الري وقد استطاع هذا النظام من تقليل كمية المياه التي يمكن استخدامها لري مساحة معينة من الأرض بنسبة 20% او30%. من الكمية المستخدمة بواسطة نظام الري السطحي، كما انه بهذه الطريقة يمكن استخدام الماء المالح لري المزروعات بفضل قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة في منطقة الجذور واحتفاظه بدرجة تركيز الاملاح في مياه التربة عند مستوى معين يقلل من حد الضرر على المزروعات.
- الري بالندى: كذلك استعمل المسلمون في الأندلس طريقة الري بالنـدى ويتم ذلك بسقي الزرعة مرة واحدة بعد ان يجمع حولها الحصى الأملس الذي لا يتسرب الماء به إلا بصعوبة فإذا تساقط الندى خلال الليل لا تشربه الأرض بل أنه يتسرب إلى الأسفل عند الجذور فتمتصه وترتوي منه. وعادة ما تنجح هذه الطريقة في المناطق الصحراوية أو المناطق القليلة المياه حيث يستعمل الندى والضباب لأغراض الري وإنجاح الزراعة.
رابعاً: جر المياه إلى قصرالحمراء في غرناطة:
يعتبر توصيل المياه إلى قصر الحمراء في غرناطة مثالاً على الإبداع الإسلامي في التقنيات الهيدرولية في الأندلس، فبعد أن استوطن” بنو الأحمر” أخذوا يبحثون عن مكان مناسب تتوفر لهم به القوة والمنعة فاستقر بهم المطاف عند موقع الحمراء في الشمال الشرقي من غرناطة. وفي هذا المكان المرتفع وضعوا أساس حصنهم الجديد “قصبة الحمراء”. ولكي يوفر له الماء أقيم سد على نهر “حدرة” شمالي التل شيدت عليه القلعة ومنه تؤخذ المياه وترفع إلى الحصن بواسطة السواقي. وبالقرب من قصر الحمراء يوجد قصر “جنة العريف” الذي شيد في أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي ويقع شمال شرقي قصر الحمراء فوق ربوة مستقلة وتظهر من ورائه جبال الثلج. وقد غرست في ساحات القصر وأفنيته الرياحين والزهور فائقة الجمال حتى أصبح هذا القصر المثل المضروب في الظل الممدود والماء المسكوب والنسيم العليل وقد اتخذه ملوك غرناطة منتزها للراحة والاستجمام.
- الإعجاز الهندسي
وكانت مدينة غرناطة تضم ما يقرب من خمسة آلاف قاطن إلى جانب الأسرة الحاكمة، وهنا ظهر تحدٍ كبير، وهو إيصال الماء إلى هذا المرتفع انطلاقا من الجبال المجاورة، والتي تُعد اعجازاً هندسياً في ذلك الوقت، لذلك كان قرار ابن الأحمر بتحويل مجرى نهر بأكمله إلى “الحمراء”، ولأجل ذلك تم بناءُ سدٍ يحصر المياه القادمة من الجبال، وبعد ذلك تم تشييد قناة مائية ضخمة طولها ستة كيلومترات، ثم الساقية الملكية التي تزوّد “الحمراء” بالمياه.
وقداقيمت الحدائق لغرض مزدوج: الأول هوتوفير مساحة ترفيهية وفي الوقت نفسه لإنتاج الغلال، وكان هذا تخطيطاً جوهرياً، اذ صممت هذه الحدائق لتخدم المصالح العلمية وتسر الناظرين ولزرع الطعام بالإضافة لزرع الأزهار.
لكن هنالك مشكلة هي أن تلة سبيكة لايوجد عليها ماء وكان اقر بمصدر مائي هو النهر الجاري في شمال الموقع، ولكن كانت المشكلة أن النهريقع بالأسفل والحمراء كانت في الأعلى. ولنقل كميات ضخمة من الماء إلى الحدائق، كان عليهم مدقنوا تريفي الحمراءوهيليستبالمهمةالسهلة، تخيلومجتمعاًيعيشعلىقمةالتلةوعندهمطلبضخمعلىالماءوهمعلىبعدمئاتالأمتارفوقمصدرالماءالذي هوالنهرالمحلي.وفيمواجهةهذاقاموابالإجراءالبديهيوالذكيوهوالصعودبواديالنهرإلىنقطةيكونفيهامستوىالماءأعلىمنهموتركطاقةالنهرتجلبالماءاليهم، لكنليسهنالكبحيرةطبيعيةفوقالحمراء، لذلكقاموابإنشاءواحدة، حيث قاممهندسوالسلطانببناءسدفوقمستوىحصنالحمراءليجمعالضغطالمائيليغذيالحصنوعلىبعدستةكيلومتراتمنالحمراءوجدالسدالذيبناهالمهندسون المسلمون حيثيكونهذاالسدشبكةصهاريجقادرةعلىتزويدمياهتكفيلملءبركةسباحةضخمةكلخمسثوانٍ الى الحمراءالواقعةاسفله.
منالصعبالتصديق عند رؤيته اليومانهذاحُفريدوياقبلثمانمئةعاملكنتحتمظهرهالعصرييكمنتصميمقديمجداً،مازالتالشبكةالمائيةعلىتصميمهاالأصليوالشيءالوحيدالذيتغيرهوموادبنائهالأنهمفيكلعاميجددونالقناةومصباتها، وكان يوجدبوابتانللسدفيالأعلىتتيحالأولىالتدفقالىنهرداروفيالجزءالمقابل، بينماتنقلالأخرىالماءالىالخزان.تتدفقمياههذاالخزانالىقناةمرصوفةبالطابو كان يسميهاالمسلمونالساقية، وكانت تغذيالحمراءفيالنهاية ,لكنتحويلمجرىنهرداروهوفقطبدايةهذاالمشروعالعملاق، فمازال علىالبناةالتغلبعلىعقبةكبيرة . لأن الخزان كانيقع فيوادٍبينثلاثتلال، ولإيصالهالىالحمراءعلىالمهندسينبناءقناةمائيةطولهاستةكيلومترات.تتعرجعبرالتلالالمحيطةبالحصنويجبانتنقلهذهالقناةمايعادل سبعألافبركةسباحةبحجمالبركالأولمبيةيوميالإعالةسكانالحمراءالمتزايدينوستعملفقطاذاحفرتفياتجاهاسفلالتلبانحدارثابت،لكنكيفيمكنحدوثهذاوثمةتليعترضالطريق، وهنايجدونحلاًجرئياً، بدلاًمنالمرورفوقالمناطقالمرتفعةقررواالمرورعبرالتلبدلامنالمرورفوقه , حفرالبناةنفقااتساعهمتروعلوهمترانعبرسفحالتلباتجاهالحمراءوكانتالمتانةالطبيعيةلتربةالحمراءضامنةلعدموجودخطرالإنهيار ,لابدانحفرقناةعبرالتلالمجاورللحمراءوالمسمىجنات العريفاستغرقشهورا، لكنمازالهنالكمشكلةكبيرةيجبحلهاتقومجناتالعريفعلىتلمختلفعنتلالحمراءيجبانيجدمهندسوالسلطانطريقةلنقلالماءمنجهةالىاخرى .لإيصالالماءمنتلجناتالعريفالمجاورللحمراءعلىالمهندسينعبورفجوةطولهاخمسةعشرمتراًتفصلالتلينوالحلبناءقناةمائيةتصلمياه نهرداروالىالحمراءتمرمنهناوفيالماضيكانتتعبرالساقيةالملكيةوهيالقناةالتيتوصلهاالىمركزالحمراء.
شكلتالساقيةالملكيةشريانالحياةلحصنالحمراءمنهناكانتالمياهتتدفقالىكلأجزاءالحمراء،كانتتزودالسكانبالماءالعذب، كماكانتتغذيالتحفالمائيةالمتعددةالتيازدانتبهاحدائقالسلاطينصممتهذهالحدائقلتكونرمزاًلمملكة غرناطةالتيحكمهاالسلاطين، كانتللحدائقوظيفةعمليةايضاً,كانتمصممةلخلقواحةوسطحرارةشمسغرناطة.
ولأن المسلميننشأوا فيالصحراء وفيبيئةكانالماء فيهاشيئاثميناًوكانتالقدرةعلىتوفيرالماءورؤيتهيتدفقأمرامحبباًاليهمبالفطرةفيالواقعانهاكثرمنمحببانهامرلاغنىعنه , المياهالجاريةمهمةبالنسبةللمسلمينلأنهميحتاجونهللوضوء ,ونلاحظفيالحمراءنادرا مايكونالماءراكداًحتىفيالبركالراكدةنجدالماءيتدفقاليهاثمتخرجمنها وهذامهمجداللحفاظعلىطهارةالماءلذلكيجبانتستمرالمياهفيالجرياناذاللحفاظعلىطهارةالماءعلىمهندسيذلك العصربناءنظاميمنعسدالرواسبللقنوات ,ويمكننارؤيةحلهمالعبقريفيشتىانحاءالحمراء , انهابركضحلةمصممةلتخفيفسرعةالماء،تاتيالمياهالمندفعةاسفلالقناةحاملةمعهاالرواسبوالبقاياوتصلالىمساحةواسعةوعميقةممايخففسرعةالماءوالوحلوالرمالالتييحملهاحتىتترسبفيالقاعبهذهالطريقةتبقىمياهالحمراءعذبةباستمرارلكنكثرةالمياهقدتكونضارةفاذافاضتالشبكةقدتتراكمالمياهوتسدالقناةمانعةالمياهمنالتدفقبحريةوللحيلولةدونهذاقررالمهندسونتركيبصمامامان،بهذهالطريقةتمرايمياهفائضةقدتفوقسعةالساقيةعبرانبوبجانبييحرفمسارهاالىقناةتصريف مبنيةداخلالجدران،منهناتخرجالمياه، حيث تبداءالمياهفيالحمراءفيالأعلىثمتهبطفيانبوبعبرمخرجالتصريفهذا, وتندفعفيالقناةوتصبفينهردارو، منجديدقديكونالمهندسون وجدواحلولمشكلةالمياةالزائدةلكنهملايسيطرواعلىقلتها ,واصبحواضحاًانالحمراءقدتستهلكمخزونهاالمائيخلالمواسمالجفافعلىقمةجناتالعريف.
يكمنحلالمشكلة،
بمجموعةضخمةمنالخزاناتأقيمتعلىأرض منخفظة
حتىتضمنالجاذبيةتدفقالماءالمستمرلريالحدائق,لإيصالالماءالىتلكالخزاناتسخرالمهندسونحماراًلتحريكأليةمسناتخشبيةمتداخلةعندمايسيرالحمارفيدوائريديرمعهدولاباًافقياًوهذاالدولاببدورهيديردولاباًمسنناًفيتصلبناعورةتغمسمجموعةمنالدلاءفيالساقيةاسفلهاوتصبالماءفيالصهريجالمثبتأعلاها
.وبهذهالطريقةاستطاعمهندسوالحمراءتحقيقحلمالسلطان
محمد بن الأحمربإنشاءواحةمنالحدائقتحيطبمجموعةالقصورالتييحميهبحصنه.
– ساعة الأسود في قصر الحمراء
وأبرز
معالم ذلك القصر ساعة الأسود التي أسست في عهد محمد الخامس، وتحتوي على اثنى عشر
أسدًا، كان الماء فيما سبق يخرج من فم كل واحد منها على رأس كل ساعة، وأذهلت طريقة
خروج المياه من أفواه الأسود العالم أجمع، حيث لم يعهد العالم التقدم الهندسي
والمعماري الذي يجعله يتوصل لهذا الأمر وخاصة أن المياه لم تخرج في وقت واحد،
وإنما كل أسد على حدى في تناغم موسيقي، فحاول الأسبان معرفة السر بحفرهم لبعض
الجوانب من حولها، ولكن أدى إلى توقف الساعة عن الاشتغال بشكلها المعروف، وصار
الماء يخرج اليوم من أفواه الأسود جميعها في وقت واحد.
- هندسة النوافير في الأندلس([35])
عمل المهندس العربي في الأندلس على إعطاء البنية المائية رمزًا كونيًا وإعجازًا هندسيًا في نقل الماء من مصادره المختلفة إلى تشكيلات حجرية من برك وأحواض ونوافير بأشكال مختلفة لتحقيق غايات بيئية وجمالية.
وقد أحسن في توظيف عنصر الماء في مختلف نماذج الحدائق والقصور والمساجد والدور والميادين، وقد كانت وظيفة الماء مهمة متعددة الأهداف والغايات، ولا ريب أن الماء يرطب الهواء ويعدل حرارته، وكذلك فإن الماء يقدم بخريره وبوقع قطراته على سطح الماء موسيقى طبيعية تتناغم مع حفيف أوراق النبات.
وأما سطح الماء فيعكس صورًا جميلة من تشكيلات النبات والزخارف النباتية بما حوت من أوراق مختلفة وزهور متنوعة ومسطحات متباينة، ويقدم الماء كثيرًا من التباين تحت ضوء الشمس وتحت الظل، ويهيئ فرصة لزراعة كثير من النباتات المائية، ولا شك أن الماء كان وسيلة الطهارة في عصر العرب المسلمين في الأندلس إذ لا تصح الصلاة بلا وضوء، ولا يتحقق الوضوء إلا من ماء جار، وأن جريان الماء كان شغل المهندس العربي المسلم في شتى أنواع الحدائق والقصور والأماكن المختلفة، فأقام شبكة تصل المصدر المائي بشتى أنواع النوافير التي تتزين بها البرك والأحواض المائية،
ولقد شكلت النوافير مركزًا تناظريًا في الحديقة الأندلسية، وقد يتعدد ذلك المركز في فناء الحديقة أوالقصر وخارجه، ويمكن أن نورد نماذج مختلفة من النوافير كانت شائعة في الأندلس.
- نموذج بركة منفردة ذات نافورة مرتفعة أو قليلة الارتفاع.
- نموذج برك منفصلة ذات نوافير مرتفعة.
- نموذج بركة ذات طابق محاطة بنوافير حجرية على شكل حيوان تصب المياه في ميزاب دائري يتفرع منه قناة تتصل ببرك سطحية ذات نوافير صغيرة قليلة الارتفاع.
- نموذج بركة سطحية منفردة ذات نوافير مركزية وجانبية تصب فيها.
- نماذج من برك منفردة ذات نوافير بطابقين.
- نموذج أحواض مائية مزودة بنوافير جانبية تفصلها بركة صغيرة مزودة بنافورة قليلة الارتفاع.
- نموذج أحواض مائية متجاورة مزودة بنوافير جانبية تتوسطها نافورة بركة ذات طابق واحد.
- نموذج حوض مائي متصل ببركة سطحية ذات نافورة قليلة الارتفاع.
- نموذج حوض مائي منفرد مزود بنوافير على شكل سباع حجرية مشوهة الوجه تمج المياه من أفواهها.
- نموذج حوض مائي مستطيل الشكل مزود بنوافير جانبية تقذف المياه على شكل أقواس.
- نموذج حوض مائي مربع الشكل مزود بنوافير جانبية تقذف المياه على شكل منخفض إلى وسط الحوض.
- نموذج بركة جدارية ذات نافورة تصب في حوض مائي.
- نماذج مختلفة من النوافير المركبة في أفواه تماثيل وأشكال مختلفة من التزيينات والزخارف.
وقد استطاع المهندس العربي في الأندلس أن يتوصل إلى معرفة التدفق والضغط وكمية الماء اللازمين لتأمين عمل النوافير المختلفة وملئ المسطحات المائية باستمرار، ويؤمن جريانًا طبيعيًا في هذه المسطحات وتبديلًا مستمر للمياه فيها، كما استطاع المهندس العربي أن يتحكم في الارتفاعات التي يجب أن يكون عليها صهريج التخزين،
كما لجأ إلى تحويل بعض أشكال النوافير إلى تماثيل حيوانية كالسباع أو الطيور أو الأسماك مما أعطاها قيمة فنية جمالية أخاذة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة نظرة الدين الإسلامي الحنيف لتلك التماثيل، ولذلك كان يجري تشويه وجوه هذه التماثيل وتحويرها. راعى أن يكون المنظر الخلفي بألوانه ومظهره الخارجي، ومساحات الضوء والظلال، جميعًا جزءًا من تكوين النافورة الحجرية التي قد تقوم بدور مركز التناظر في تصميم المكان، وقد زرعت الأشجار والشجيرات والنباتات القابلة للتشكيل لتقوم بدور المنظر الخلفي والغلاف الذي يحيط بالنوافير الجميلة ذات الألوان الفاتحة، وذات التصميم الهندسي الدقيق، وفي بعض الحالات كانت السماء هي المنظر الخلفي النموذجي لها، ومن الأمثلة على ذلك مجموعات النوافير في جنة العريف في غرناطة.
فقد أحكم المهندس العربي في الأندلس تصميم النوافير الأندلسية بدقة متناهية، وعبقرية هندسية، فأصبح انبثاق الماء تابعًا لإرادته، إن أراد رفعه لارتفاعات وبأشكال مختلفة، وإن أراد أنزله من علو شاهق في أشكال جذابة رائعة.
- “محكمة المياه” وإدارة الموارد المائية في الأندلس:
إن محددات الإطار التشريعي للماء في الأندلس ترجع إلى ثلاثة عناصر جوهرية وهي:
- العنصر الأول: التشارك، مستمدّ من القرآن الكريم والسنّة النبويّة، ويرمي إلى إيجاد نوع من “العدالة الاجتماعية” في استغلال المياه بطريقة تشاركيّة تؤدي إلى المساواة في الانتفاع به.
- العنصر الثاني : نفي الضرر، إن مبدأ نفي الضرر يهدف إلى حماية المصلحة العامّة للشركاء، وتبرز أهميته عند نشوب النزاعات.
- العنصر الثالث : العُرف. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية الأعراف والعادات في المناخ التشريعي للماء بالأندلس، وترجع إلى تجذّر “فقه الواقع” هناك وانفتاحه على المجتمع. وقد ساهمت المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك “طبيعة البنيات السوسيولوجية للمجتمع الأندلسي” في ترسيخ الأعراف.
ونرى أن العلاقات الاجتماعية المتمحورة حول “المسألة المائية” في الأندلس قد تباينت بين التضامن والخصومات. فالاستفادة من الموارد السقوية كانت تخضع للضوابط الشرعيّة والعرفيّة التي مكنت من سيادة ما سمي بـ”الرّي التوافقي“، وتمتين ثقافة التضامن في تدبير شؤون السقي (إقامة التجهيزات السقوية وصيانتها جماعياً)، واعتماد نظام تعاقدي تحددت بموجبه”النّوْبة“على أساس العامل الزمني، والحجم الإجمالي للصّبيب، ومساحة الأرض وعدد أفراد الجماعة المستفيدة. وقد عملت الأحكام القضائية والفتاوى الفقهية على مسايرة العادات والأعراف في تمتين أواصر التراضي أثناء الاستغلال الجماعي للمياه.
وهنا يجب لفت النظر إلى ما يسمى بـ “فقه المعمار المائي الحضري“، أي مجموع الأحكام الشرعية والعرفية والهندسية المنظمة لإنشاء المنشآت المائية وتطورها. ولأن الماء كان له أثر حيوي في تصميم المدن الأندلسية وتنظيمها ووظائفها، فقد أفرز خطتين معماريتين: الخطة الشريطية، أي امتداد بعض الأمصار على طول الأوديّة والسواحل (مثل مالقة وطريانة)، والخطة متعددة النوى، المتسمة بالتبرعم بفعل تفرع المدن بسبب تفرع المجاري المائية التي أقيمت عليها (مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة)([36]). كما نلاحظ تركز الأمصار الأندلسية الكبرى في وسط وجنوب البلاد “بفعل كثافة الأودية والعيون الدائمة الجريان هناك” ([37]).
وقد تبع اعتبار المدن وأحوازها وحدات إدارية بضع صور إدارية لا نجد لها شبيها في المشرق، كاتباع الأنهار أو أجزاء منها للمدن التي تقع عليها أو الأقاليم التي تقع فيها، مثال ذلك قول العذري في كلامه عن إقليم جلق من أقاليم سرقسطة:”ونهره يسقي ما وازى قنطرة سرقسطة عشرين ميلاً. ومخرج نهر جلق (El Gallego) من جبال السيراطانيين، ثم يخرج من ناحية وشقة إلى سرقسطة، ويقع في إبرة والجزء الأعلى من نهر جلق يروي من الصخيرة إلى قنطرة سرقسطة عشرين ميلاً”. فهنا نرى بوضوح أن النهر تابع للإقليم، بل إن الأجزاء التي يرويها محددة تحديداً تاماً، كما تحدد النواحي التي ترويها الترع والقنوات في نظم الري الحالية. وتسمية النهر باسم الإقليم هنا ليست تسمية جزافية بل لها معنى التبعية الإدارية. ومثال ذلك أيضاً قوله في الكلام عن إقليم شلون(El-Jalon): “وهو غربي سرقسطة ونهره يسقى من قرية قبانش وركلة إلى باب سرقسطة 40 ميلاً ، وحكى بعض من يعرف عن نهر شلون أنه يعم بالسقيا نحو 70 ميلاً، ومعنى ذلك أن أربعين ميلاً من مجرى شلون تابع لإقليم شلون، والباقي خارج عن هذه التبعية. وعلى هذا الأساس قالوا نهر مرسية ونهر بلنسية وما الى ذلك، فقد كانت لهذه الأنهار أسماؤها الجغرافية وكان العرب يعرفونها، ولكن نسبة النهر هنا تحمل معنى التبعية، أي أن نهر مرسية داخل في حوز مرسية وأقاليمها، ونهر بلنسية كذلك. بل إن مجاري الأنهار الطويلة كانت تقسم، فيدخل كل قسم منها في حوزة مدينة([38]).
وإن إجراء التوزيع بالأدوار في منطقة بني البوفار يتوافق بشكل عام مع ما هو موجود في جنوبي الجزيرة العربية (أدوار سبعة أيام تحسب من شروق الشمس إلى غروبها) وذلك على الرغم من أنه يشذ عنه أيضا إلى حد ما. فأحياناً يوزع الماء للمزارعين الذين يرغبون في ري حقولهم عن طريق وحدات زمنية تقاس بالساعات المائية أو أية أدوات أخرى يراقبها مسؤول رسمي، وليس ثمة مسؤول يعين للإشراف على توزيع الأدوار، الذي يتم بالاتفاق ما بين المزارعين. وهذا إجراء نادر في شرقي إسبانيا، لكنه ليس مما لم يسمع به([39]).
ولقد تمتعت القنوات والجداول في الزراعة الأندلسية بأهمية كبيرة وخطيرة دفعت هذه الخطورة والأهمية الى انشاء محاكم خاصة بالمياه كمحكمة المياه في بلنسيه والتي دارت شؤونها حول قضايا الري وتوزيع المياه من حيث كمياتها واوقاتها([40])، وقد انشئت هذه المحكمة من قبل العرب حيث أسسها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر([41]) وكان قاضي بلنسيه آنذاك عبد الرحمن بن حبال، وذلك في سنة 349هـ/960م ومازالت موجودة إلى الآن([42])، فعهد الخليفة عبد الرحمن الناصر كان من أزهى عهود الأندلس، وهو العهد الذي استمر لنصف قرن(300–350هـ)، واستطاع في عهده أن يغير حال الأندلس من ضعف وتفكك إلى قوة ومجد وازدهار. فقد كان من أهم آثار عهده إنشاء هذه المحكمة، والتي احتفلت إسبانيا بمرور ألف عام على إنشائها عام 1961م، وحضر الملك الإسباني خوان كارلوس جلساتها أربع مرات، واعتمدت في الدستور الإسباني 1978م، وصارت جزءا من قانون مقاطعة بلنسية الصادر 1982م، ومن قانون الماء الإسباني الصادر 1985م، وأخيرا فقد سجلتها منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي الذي يجب المحافظة عليه في أيلول2009م.
وتعد هذه المحكمة ميراثاً للشعب الأندلسي بشكل خاص وأوروبا والعالم بشكل عام([43]). ولم يقف الأمر عند إنشاء المحاكم بل كانت هناك عناية واسعة بنظافة تلك المياه والمحافظة عليها ولقد كان المحتسب يأمر بمنع الدواب من الاقتراب من المياه ويعمل على منع النساء من غسل الملابس في الاماكن القريبة منها إلا في أماكن محددة.
و“محكمة المياه” هذه ما زالت تعقد حتى اليوم وتحافظ على تقاليدها ونظمها العربيةكانت تمثل نموذجاً للمسؤولية الاجتماعية والحلول المبدعة التي يفرزها المجتمع ويقوم عليها ويبقيها، كما اعتبرت أيضاً “مثالاً عمليا للتشريعات المتعلقة بالتدبير القانوني والإداري للسقي” في الأندلس وعن قوانينه وخصوصياته.
تحولت بلنسية التي أنشأها الرومان على ساحل البحر المتوسط في عهد المسلمين إلى أرض الحدائق والجنات، رغم قلة أمطارها، وذلك بأثرٍ مما أبدعه المسلمون من أنظمة الري والتحكم بالمياه من خلال ما بنوه من سواقٍ وسدود على نهر توريا الذي يمد المدينة بحاجتها من الماء، وهذه التقنيات التي تركها العرب منذ ألف سنة بلغت من التطور والإبداع حدًّا عظيما، ويكفي أنها ما تزال هي الأساليب المعتمدة في الزراعة حتى الآن.
وهذه المحكمة نشأت كنوع من المحاكم المتخصصة التي تسد حاجة سريعة في تنظيم الماء في بلنسية، وهي تتألف من ثمانية أعضاء يمثلون السواقي الثمانية القائمة على نهر توريا في بلنسية (وهي سواقي قوارت ــ مصلاتة ــ ترمس ــ مستليا ــ فبارة ــ رأس كانيا ــ روبية ــ بيناشير وفيتمار)، فلكل ساقية مستفيدون منها –وهم أصحاب الأراضي الواقعة حولها- وهم ينتخبون فلاحاً منهم ليكون قاضياً عليهم، وتكون مدة انتخابه لسنتين أو ثلاثة، وحين يجتمع الأعضاء الثمانية يترأسهم الأكبر سناً، ثم يختارون بالانتخاب رئيس المحكمة ونائبه.
تعقد جلسة المحكمة منتصف نهار يوم الخميس من كل أسبوع مثلما كان ذلك في عهد المسلمين، وفيها يتقدم الشاكي بشكايته ويدافع المُتَهَّم عن نفسه، ولا يشترك قاضي هذه الساقية في تداول شأن القضية بل يحكم فيها السبعة الآخرون، وتعد أحكامهم نافذة وغير قابلة للاستئناف أو الطعن أمام أي جهة أخرى، ويقوم بتنفيذها حُرَّاس السواقي تحت إشراف قاضي الساقية الذي لم يشترك في القضية ويعد هو المسؤول عن تنفيذ الأحكام.
وحراس السواقي أولئك هم بمثابة الشرطة المتخصصة، إذ بخلاف تنفيذهم للأحكام فهم أيضا من يبلغون المحكمة بأي تعديات أو مخالفات وقعت في ناحيتهم.
قضاة المحكمة هم من الفلاحين الذين يزرعون الأرض ويتكسبون منها بما يجعلهم متخصصون في هذا المجال ويعرفون دواخله وتفاصيله وأساليب الحيل والمخادعات فيه، وهم ما زالوا يرتدون الثياب السوداء التي كان يرتديها الفلاحون في بلنسية منذ العهد الإسلامي، ويجلسون على مقاعد جلدية كنحو التي كان يجلس عليها القضاة قديما، وجلسات المحكمة كانت ولا تزال علنية يمكن لأي امرئ أراد أن يحضرها، كما وتعقد المحكمة في ذات الفناء الذي كانت تعقد فيه غير أنه قديما كان فناء مسجد رحبة القاضي –وهو المسجد الجامع في بلنسية- بينما صار الآن فناء كاتدرائية بلنسية بعد هدم المسجد في زمن إنهاء الوجود الإسلامي في الأندلس.
وتضمن المحكمة استمرار نفسها من خلال التمويل الذاتي، إذ يحصل القضاة على نسبة من رسوم الري ونسبة من الغرامات التي توقع كعقوبات على المخالفين، وتُكفل لهم نفقات تنقلهم.
وفي حين كان الاجتثاث الإسباني للمسلمين في غاية الجنون، فإنهم ولافتقادهم أي أساليب تنظيمية للزراعة والتحكم في الماء فقد أبقوا على محكمة المياه هذه كأمر لابد منه لكي لا تخرب بلنسية، إلا أن الخراب أصابها من وجه آخر وهو نقص ذوي الخبرة والمهارة في الزراعة الذين كانوا من المسلمين، إذ صاروا بين قتيل وأسير ومهاجر.
ومن الملاحظ أن بلنسية ما تزال تستعمل المقياس العربي “فيلان” في قياس كميات المياه التي تحصل عليها كل ساقية بحيث ينضبط التوزيع العادل لمياه النهر بحسب كل ساقية والمساحات التي ترويها، والتي تبلغ أكثر من 40 ألف فدان. وبهذا تمثل محكمة المياه البلنسية الأندلسية نموذجا لمؤسسة اجتماعية ذات نفع عام، استمدت فكرتها وخلودها من خصائص الحضارة الإسلامية التي أنبتتها.
كان ميدان الري الخاص بالزراعة الجديدة نفسه مزيجاً مركباً من التكنولوجيا (في شكل الملحقات الهيدرولية المطلوبة لتحويل المياه أو توصيلها أو ضخها لغايات الري) والمؤسسات (اتخاذ الترتيبات الضرورية لتوزيع المياه بين فئات المزارعين، بما في ذلك مفاهيم الحقوق المائية ومبادىء تحديد الحصص ونظام المقاييس وآليات الإدارة والقضاء في النزاعات والمراقبة الاجتماعية لتقسيم المياه) إن الأعراف والقواعد التشريعية التي تنظم بموجبها الزراعة الهيدرولية لتشكل –وهذا ما أود أن أؤكده- تكنولوجيا بحد ذاتها، لأنه لولاها، لما أمكن تشغيل المنشآت الفيزيائية والآلية للري ووضعها موضع التنفيذ([44]).
- أهم علماء الزراعة في الأندلس وانتاجهم
كانت الأندلس والمغرب العربي متخلفين علميًّا
وحضاريًّا عن المشرق الإسلامي في مجال الزراعة حتى أول القرن التاسع للميلاد، وذلك
عندما تولى الخلافة عبد الرحمن الناصر،الذي سعى إلى تدارك هذا القصور، وذلك بإرسال
البعثات العلمية إلى المشرق العربي للدراسة في بغداد ودمشق والقاهرة، وجلب الكتب
المؤلفة والمترجمة إلى العربية. وكانت هذه البعثات بداية لنهضة علمية زراعية في
الأندلس حيث ظهر فيها علماء أجلاء ادخلوا الكثير
من العلوم الجديدة إليها.وفي تلك الأثناء ظهرت مدرستان في علم الزراعة الأندلسية:الأولى،
اهتمت بعلم العقاقير والنباتات الطبية، وكان من روادها ابن جلجل([45])وابن
وافد([46])وابن
سمجون([47])
والغافقى([48])
وابنميمون([49]) وابنالبيطار([50]).
والمدرسة الثانية، اهتمت بعلم الفلاحة والنبات، وكان من روادها ابن بصال
الطليطلي وابن حجاج الاشبيلي والحاج الغرناطي و ابن العوام و
الشريف الإدريسي وأبو
عباس النباتي.
والحديث
الحاسم في ولادة المدرسة الزراعية الأندلسية كان بلا ريب ظهور تقويم قرطبة
(Calendario
de Codoba)لعريب بن سعيد ففي هذا
الكتاب المهدي إلى الحكم الثاني تشير المواد الزراعية المدرجة عموماً في ختام كل
شهر من شهور السنة، إلى زراعة الأشجار والجنانة والبستنةوعلاوة على ذلك، ثمة أحداث
تدل على احتمال تأليف إبن سعيد لرسالة في الزراعة يمكن أنها تضمنت كل بيانات علم
الزراعة التي أدرجها المؤلف لاحقاً في تقويم قرطبة، فإذا صحت هذه النظرية
فإن الرسالة المعنية ، التي لم تصل إلينا، ستكون أول ما كتب في الزراعة الأندلسية.
أما الرسالة الثانية في هذا الميدان، مختصر كتاب الفلاحة، فتنسب إلى شخصية
مرموقة ثانية، معاصرة لإبن سعيد، هي شخصية أبي القاسم الزهراوي طبيب البلاط ايام
الحكم الثاني والمنصور بن ابي عامر([51]).
ومن ثم بعد ذلك حدثت نهضة غير مسبوقة في الأندلس
في جميع المجالات خاصة في مجال الزراعة والفلاحة فعمرت المدن وكثرت الخيرات وانتشر
العلم خاصة في القرنين الخامس والسادس الهجريين
واحتلت دواوين الفلاحة حيزًا كبيراً مجالات العلوم كافة، فسمي هذا العصر بعصر نهضة
“المدرسة الزراعية الأندلسية“والتي كانت تتمثل على مستوى التأليف
والفكر الفلاحي في الموارد التالية:
1. مجموع الفلاحة لابن وافد.
2. كتاب الفلاحة لمحمد بن إبراهيم بن بصال.
3. كتاب المقنع في الفلاحة لأبي عمرو أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي.
4. كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي([52]).
5. زهرة البستان ونزهة الأذهان للطغنري الذي أهداه للأمير أبي طاهر تميم بن يوسف
بن تاشفين.
6. كتاب الفلاحة لأبي زكريا يحيى بن محمد بن أحمد بن العوام الأشبيلي من رجال
القرن السادس الهجري([53]).
وهذا القدر الكبير من الأعمال الفلاحية في الأندلس يجعل مؤرخي العلوم أمام ظاهرة فريدة من نوعها، حيث تقول الباحثة لوسي بولنز(Lucie Bolens): إنَّ هذه المرحلة ؛عبارة عن ثورة خضراء كبيرة، ذات تقنيات زراعية عالية. ويشاركها نفس الرأي جورج سارطون([54]) في المدخل إلى تاريخ العلوم، وقد نوه بنفسه حين صدور كتاب الفلاحة لابن بصال.
ومما لا شك فيه أن مناخ الأندلس وأرضها وتربتها المتعددة كانت قد ساعدت على تجارب ابن بصال وابن حجاج وابن العوام، كما أن معدل تساقط الأمطار في هذه الحقبة مدار الدراسة هو بمعدل 400 و600 ملم3، كان يسمح بإقامة المشاريع الزراعية، مع تقنيات الري المتطورة .
كان من أهم آثار العرب المسلمين في الأندلس هندسة الحدائق والرياض الخاصة والعامة، مما يدل على ذوق فني سليم في تنسيق الحدائق، جمعت بين الرقة والبساطة. حيث كان علماء الفلاحة بالأندلس في قمة تطويرهم للعلوم الفلاحية والبيطرة، فقد جابوا أقطار الدنيا للبحث عن أنواع النباتات الطبية والأزهار الجيدة ، وقد تفنَّنُوا في رسم وبناء الحدائق التي اشتهر بها أهل الأندلس الذين أقاموا القرى الفلاحية والمنيات والجنات والبساتين.
وثمة عامل آخر ذو أهمية بالغة ينبغي أخذه بعين الاعتبار لدى التعرض للازدهار الكبير الذي شهدته الأندلس في الفترة اللاحقة، هو ظهور الحدائق النباتية أو الحدائق التجريبية التي جرى العمل فيها على أقلمة نباتات جديدة أو على تحسين أنواع نباتات معروفة أخرى في تربة شبه الجزيرة الإيبيرية بواسطة البذور والجذور والفسائل التي جلبت إلى الأندلس من بقاع نائية في المشرق العربي. وكان من المعتاد أن يجمع البستانيون في أسفارهم نباتات غريبة كي يجروا عليها اختباراتهم وتجاربهم في وقت لاحق، وكانت رصافة عبد الرحمن الداخل أول ما عرف في هذا المضمار([55]).
وبفضل السياسة التي انتهجها أمراء قرطبة الأمويون، لاسيما عبد الرحمن الداخل؛ أدْخِلَت إلى الأندلس نُظُمُ الفلاحة وأساليبُ الري الشامية، كما جلبت نباتات وأشجار مثمرة من بلاد الشام. وأدخل الفاتحون الجدد إلى الأندلس محاصيل جديدة ([56]) معظمها تعتمد على الري، ومع المحاصيل الجديدة أُدخلت إلى الأندلس وسائل جديدة في الزراعة، فبعد أن كانت الأرض تظل بورًا في فصل الصيف ولا تنتج إلا محصولاً شتويا أصبحت تُستغل-باستخدام الرَّي- على مدار العام، كما أدخل الفاتحون نظام الدورات الزراعية، كزراعة الذرة صيفًا، بعد زراعة القمح شتاءً، وتطلب ذلك دراسة أنواع التربة واستخدام الأسمدة، وفيها صنف الأندلسيون كتبًا خاصة في القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي؛ تناولت أنواعها وخصائصها، كما قام الفاتحون بإصلاح نظم الري القديمة في الأندلس، وتحسينها وتوسيع شبكتها في كثير من الأحيان، مما أدَّى إلى توفير مزيد من الماء لسقي مساحات أوسع من الأراضي، فازدادت رقعة الأرض السقوية وغلاتها، وازدادت بالتالي مداخيل المزارعين ، وأصبحت أكثر نباتًا وأقل خضوعًا لرحمة التقلبات المناخية ..
كما أدرك الخبراء الزراعيون اهمية الدور الذي يؤديه خلط الأسمدة في بعض الحالات، وتمكنوا من الارتقاء بالزراعة الأندلسية إلى مستوى لم يستطع اللاحقون التفوق عليه حتى القرن التاسع عشر الميلادي، بفضل التطور في علم الكيمياء، ولقد أمر الحكام الأسبان في عصر التنوير (القرن الثامن عشر الميلادي) بترجمة رسالة إبن العوام إلى اللغة الإسبانية إدراكا منهم لذلك التطور، كما ترجمت الرسالة ذاتها إلى الفرنسية في وقت لاحق لوضعها في تصرف المزارعين الجزائريين([57]).
من الإبداعات التي تستدعي الكثير من الاهتمام في ذلك الوقت كان انتاج نباتات المشتل. فقد برع في ذلك العالم “ابن ابي زكريا” الذي كتب كتاب “الفلاحة” خلال فترة العصور الوسطى والذي احتوى على اكثر التفاصيل التي كتبت عن الهندسة الزراعية في حينه وقد ترجم إلى الإسبانية تحت عنوان “مسلم من الاندلس” وقد استفاد منها المزارع الإسباني وخاصة فيما يتعلق بزراعة الحمضيات وبعض الممارسات التي لا تزال تطبق لغاية الآن.
وفي هذه المجالات ظهرت عبقرية الطغنري، وابن بصال وابن العوام، ومن قبلهم ابن وافد الطليطلي الطبيب والصيدلي الكبير كما تنعته الدراسات الأسبانية (تـ467هـ/ 1075م) الذي خدم الأمير المأمون(1037 -1075) وزرع له جنة السلطان، وهي مضرب المثل في الحدائق الأندلسية التجريبيةما بين التاج والقنطرة([58])، وابن بصال هو الذي خدم أيضًا بنفس الحديقة النموذجية وعند نفس الأمير العالم والفيلسوف، والمؤلف المجهول من القرن الثاني عشر الميلادي صاحب” ترتيب أوقات الغراسة والمغروسات وأبي الخير الإشبيلي، وهذا كله يدل على مكانة المسلمين وما وصلوا إليه من عبقرية في علوم الفلاحة، فقد كانوا عظماء وفلاسفة ونوابغ في الفنون والعلوم النظرية والتطبيقية، ولم يكونوا نقالة لكتب وبحوث ونظريات غيرهم، كما يعتقد بعض الجاحدين لفضائل دور العرب والمسلمين في بناء قواعد العلم الحديث، فهم الذين بنوا الأسس العلمية بأمانة وإخلاص والدعوة إلى ذلك وجعل البرهان دليلا شاهدًا([59]) فقد كان كتاب “زهر البستان ونزهة الأذهان ” للطغنري(أبي عبد الله محمد بن مالك الطغنري) من قرية طِغْنر بضواحي غرناطة)(Tignar) من أهم المجاميع في الفلاحة والبيطرة والذي كان في خدمة الأمير الزيري عبد الله بن بلقين حاكم غرناطة(465-483هـ/1073-1090م) ثم دخل في خدمة الأمير اللمتوني أبي طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين حاكم غرناطة المرابطي شقيق أمير المسلمين علي، والذي أُهْدِيَ إليه الكتاب كما هو مسجل في ديباجته، وهذا الجمع الكبير من العلماء كانوا أعلاماً في علم الفلاحة وتقنياتها وتجاربها وشكلوا ثورة علمية خضراء كما تقول الباحثة لوسي بولنز (Lucie Bolens) من جامعة جنيف حيث درست هذه الكتب في أكثر من دراسة([60]).
اما
في الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر فقد قام العالم “أبو
الخير” بتأليف كتابه عن الفلاحة وتطرق فيه إلى الكسب غير المشروع في
الفلاحة الامر الذي يتطلب معرفة دقيقة بالطبيعة والاشجار والمواسم. وقام بتصنيف
الأنواع الأساسية من الأشجار مثل الأشجار الزيتية (كالزيتون والغار) والاشجار
الراتنجية (كاشجار اللوز والخوخ والبرقوق)، والاشجار الحليبية (كالتين والتوت
والعنب والرمان). كما ذكر العالم “ابن البصال” بعض تصنيفات النبات حسب
نجاح أو فشل الطعوم فيها. حيث صنف النباتات إلى 4 مجموعات وأضاف مجموعة خامسة
تتكون من النباتات المائية دائمة الخضرة. وقام بتصنيف النباتات حسب المناخ إلى 7
مجموعات ووضعت الحمضيات (البرتقال والليمون) كاشجار مناسبة للبيئة الاندلسية. أما
بالنسبة للمعلومات الخاصة بالاسمدة فقد اهتم بذلك كل من ابن البصال وابي
الخير وابن العوام في عمليات تحديد اوقات الاستخدام وانواع الأسمدة حسب مصدرها
والفوائد المختلفة لها سواء كانت طازجة او مختمرة وسواء كانت من الماعز او الخيول
وحول إعطاء أفضل النتائج المرجوة بالنسبة لنمو النباتات والأشجار المزهرة أو
المثمرة.
ولقد اشتغل ثلة من المستشرقين بنشر التراث العلمي في علم النبات والفلاحة والحيوان
وغيرها لحاجات علمية أحيانا وتنموية أحيانا كثيرة، نظراً لما يحويه هذا التراث من
تجارب علمية مفيدة في التطبيقات الزراعية المعاصرة، ومن تأسيس نظري ومنهجي لهذه
العلوم، يتضمن أصولا علمية وقواعد عملية وقوانين تجريبية أثرت بشكل مباشر على
النهضة الغربية في بلاد الغرب. فنشروا كتباً مهمة وترجموها إلى لغاتهم، بينما بقيت
مجهولة بين القوم الذين أنتجوها ابتداء. ومن أبرز هذه الكتب : كتاب (الفلاحة
الأندلسية) لابن العوام الإشبيلي(ت 580 ه/ 1184م)، الذي يعتبر موسوعة
علمية ضخمة في مجال علم الفلاحة، نشره مع ترجمة إلى الإسبانية ومقدمة علمية سنة
1802م جوزيف أنطونيو بانكيري J. A. BANQUERI، وترجمه إلى الفرنسية ترجمة ناقصة كليمون مولي
J.
J. Clément-Mullet في الفترة بين عامي 1864 و 1867، وكان قد
ترجم قبل ذلك إلى اللغة العثمانية عام 1590 من قبل محمد بن مصطفى، ويوجد نسخة من
هذه الترجمة في المكتبة العامة باسطنبول في قسم ولي الدين تحت رقم 2534 ، ونسخة
أخرى في مكتبة بورصا العامة في تركيا حسب ما يفيد بروكلمان. كما ترجم إلى لغات
أخرى كالإيطالية والانجليزية والأردية. ولم ينشر الأصل العربي محققاً إلا سنة
2012م([61]) .
وكان ابن بصال الطليطليمن أوائل من ألف في الفلاحة، ومارسها في بلده طليطلة علمًا وعملًا، بحيث كان ينتقل من الدراسة النظرية إلى العمل التجريبي، ويعتبر كتابه أحد أهم الكتب التي وصلتنا في مجال الزراعة الأندلسية، ويضم الكتاب جميع ما يتعلق بفن الزراعة. يذكر محقق “كتاب الفلاحة” لابن بصال([62]) الإشارات المتعلقة بابن بصال في كتب معاصريه ومن جاء بعده من المؤلفين وهي مرتبة ترتيباً تاريخياً مبتدئين بـ”كتاب النبات” لأبي الخير الأشبيلي – المجهول المؤلف زمن نشر كتاب ابن بصال- الذي عنوانه “عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب”، وهو الكتاب الذي قام المستعرب آسين بلاسيوس بدراسته، وقد ألف كتابه بعد سنة 488هـ/1095م، وأبو الخير الأشبيلي يردد بين حين وآخر صدى مذكرات جرت بينه وبين ابن بصال في الأندلس على ما يظهر، ولعلها كانت في قرطبة أو إشبيلية.
قام كل من خوسيه مارية مياس بييكروسا، ومحمد عزيمان بنشر مقالين في مجلة الأندلس عام 1362هـ/ 1943م، درسا فيهما الترجمة الإسبانية لكتابين عربيين في الزراعة، أحدهما “مجموع في الزراعة “للطبيب والنباتي الطليطلي أبي المطرّف عبد الرحمن اللخمي، المعروف بابن وافد، والثاني كتاب “القصد والبيان” لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم إبن بصّال، المعاصر لابن وافد، ولم يكن الأصل العربي للكتابين معروفًا، فظل الرجلان مجهولين عند معظم الباحثين، ولم تكن توجد إلا إشارات عابرة لكتاب ابن بصال في كتابات بعض المؤلفين المتأخرين، وإذا لم تكن الترجمتان تامتين، فإن لهما أهمية علمية وتاريخية لا غبار عليها.
- الخاتمة
وخلاصة القول: إن العرب المسلمين قد سجلوا نتائجهم في كتب عديدة تمثل مجموعة رائعة من آثار البحث العلمي، فمنها :
- ما كان ميله نحو الوجهة العلمية التطبيقية، فيعرف الناس بالطرق التقنية الواجب اتباعها في استثمار مقدرات الطبيعة وابتكار طرق مهمة وحديثة في الزراعة والري، واستخدامها لضمان الزيادة في الإنتاج، وتحسين المستغلات كما ونوعًا، وخزن الثمار الناتجة عنه، والحفاظ عليها من التعفن والفساد…
- ومنها ما توجه وجهة تطبيقية ثانية تتمثل في درس خواص النباتات الطبيعية وتجربتها، معتمدًا على المشاهدة الحسية والتجربة المادية، مدققا مدى صلاحيتها والمقادير الواجب استعمالها لإصلاح الأبدان ومعالجة الأدواء([63])
- ومنها ما توجه وجهة علم طريفة ، فدقق في وصف النباتات ، وتعرف على ذواتها ومنابتها ووصف سوقها وأوراقها وجذورها وأزهارها وثمارها وبذورها، وآلت البحوث إلى التصنيف في عالم النبات وخصائصه، وقد أدرك العلماء أهمية هذه المرحلة التي لم تعرفها أوروبا إلا في مطلع القرن السادس عشر، وفي هذا الشأن نلاحظ أن أول تصنيف ظهر بأوروبا كتاب دي بلانتيس(De Plantis) من تحرير أندريا سيسلفينو(Andrea Cesalfino) الإيطالي حوالي عام 1524م ونشر بفلورنسا عام 1563م. إن تراث المسلمين في هذا الميدان جد حيوي، وهو ميدان الزراعة والري.
[1]) جاك ريسلير، الحضارة العربية، دار عويدات-بيروت-باريس، تعريب خليل أحمد خليل، ص: 118
[2]) توماس ف. غليك، التكنولوجيا الهيدرولية في الاندلس، منشور ضمن كتاب الحضارة العربية الاسلامية في الاندلس، ترجمة: صلاح جرار، ج2، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت –1999، ص: 1346
[3])توماس ف.غليك، التكنولوجيا الهيدرولية في الأندلس، ص:1348
[4]) أميريكو كاسترو: Américo Castroفقيه لغويومؤرخ ثقافي إسباني، وُلد في كانتاجالو في ولاية ريو دي جانيرو في البرازيل في 4 مايو عام 1885م انتمى كاسترو إلى جيل عام 1914. وتُوفي في يوريت دي مار في إسبانيا في 25 يوليو عام 1972
[5]) توماس ف. غليك، المرجع نفسه، ص: 1349
[6]) خوان فيرنيه، العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية في الأندلس، ترجمة أكرم ذا النون، (الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس)،الجزء الثاني، ص:1304
[7]) جاك ريسلر، الحضارة العربية، ص: 156
[8]) هناك رأي لكبار علماء التاريخ الأندلسي بأن كلمة (Favara)من الكلمة العربية (فوارة) وهو مصطلح للتعبير عن كثرة المياه.
[9])(كلمة زرب وجمعها زروب تشير الى قناة التصريف “السرب” بالنلنسية والقشتالية) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1352 _1353
[10]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1351
[11]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1352
[12]) الاصطلاح العام المستخدم في التعبير عن وحدات قياس الماء في شرقي إسبانيا والمسمى fila يطلق عليه(hila)في بالنسيا و(hilo) في قشتالة، فالكلمة تعني خيط. ونعرف من خلال أسماء الأماكن مثل فيتانارا أو الفيتامي ، ومن خلال التوثيق، أن fila هي ببساطة ترجمة بلغة الرومانس لكلمة خيط وكلمة fila في كل مكان تقريباً تعني وحدة حساب في النظام الإثني عشري، أي أنها تخيلاً تعبر عن حصة الفرد أو المجموعة أو البلدة من الماء كحصة من الكمية الإجمالية للماء في الجدول، أو جزء من الجدول ، أو في مرحلة ما، من مراحل سيره. وكلما كان لا بد من قياسها، كما في حالة شح في المياه فإنها كانت تحول –كما يقتضي المنطق- إلى وحدات زمن (ساعات او ايام من الماء) . إن شيوع وحدات القياس في النظام الإثني عشري من أجل الري في أرجاء العالم الإسلامي كافة يجعل من كلمة (fila) أساس الحجة التي تبرهن الدمغة العربية على ترتيبات التوزيع، جنباً إلى جنب مع الإصطلاحات لدورة الري مثل (tanda( (المجهولة المصدر، لكن يعتقد أنها من أصل عربي في بالنسيا، و”dula” (من دولة) ، التي تعتبر مصطلحاً عاما تقريبياً لكلمة (دورة) في اليمين وسلسلة الواحات الصحراوية، وكلمة (ador) (المشتقة من” دور” dawr)، وهلم جرى. أما في القنوات فكان الماء يقسم إلى أقسام تامة بواسطة منشآت مادية تدعى القواسم (partidor)في اللهجة القطلانية وفي القشتالية، ولكن يوجد إلى جانب ذلك عدد من الكلمات المرادفة العربية الأصل في الأنظمة التي سادت بعد الاحتلال المسيحي، مثل((almatzem من كلمة “مقسم” (maqsam) في غانديا (gandia) ، وكلمة شيستار (sistar) من “شطارة ” في منطقة“Vall de SegÒ” وكلتهما من كلمات عربية تعني”يقسم”). توماس ف.غليك، المرجع نفسه ، ص:1354
[13]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1353
[14]) الناعـور: وهو من الادوات التي نقل العرب استخدامها من بلاد الشام الى الاندلس واستخدمت لسقي الحقول ولا تزال مستعملة في بعض مناطق اسبانياولا يزال يلفظ باسمه العربي في الوقت الحاضر (Noira) فضلا عن (Garraffu) الذي يغرف به بواسطة الناعور. والناعور من الآلات المائية التي تركب على= = الانهاراو الجداول الدائمة الجريان او على قنوات الري الرئيسية كما في مناطق الري في مرسية ، توماس ف.غليك، المرجع نفسه ص: 1357، وتتكون من دولاب دائري مصنوع من الخشب قائم بشكل عمودي على منسوب الماء وحوله اوعية فخارية، او علب من التنك حول دائرته مربوطة بشكل منظم بحبال قوية على طول دائرته. وسمي بالناعور لصوت يخرج منه وكل الدوالي التي تغرف بالدور فهي المنجنونات منها منجنون ومنجنينويدور هذا الدولاب بقوة تيار الماء فيسمى بالناعور المائي ، ميتز،الحضارة الاسلامية، ج2،ص:338 . ويستخدم الناعور لرفع الماء اذا كان على مسافة قريبة من سطح الارض، كما يستخدم بالري في الاراضي المرتفعة وفي وديان الانهار مثل وادي آنة وابرة وتاجة. ومن النواعير التي كان لها الاثر الكبير في الزراعة ناعورة طليطلة على نهر تاجة حيث بلغ ارتفاعها في الجو تسعين ذراعاً وهي تصعد الماء الى اعلى القنطرة ويجري الماء على ظهرها فيدخل المدينة . ونواعير بلنسية، والنواعير الموجودة على الجداول المتفرعة من نهر مرسية والتي تسقي جناتها، فضلاً عن النواعير الموجودة في قرطبة التي تصعد الماء من الوادي الكبير الى بساتين قرطبة فتسقيها، وناعورتان على نهر ابرة قرب سرقسطة تداران بقوة الماء، وللمكانة التي احتلتها الناعورة واثرها الكبير بالزراعة اطلق على المكان او القصر الذي توجد به الناعورة بأسمها كقصر الناعورة غرب قرطبة خلال فترتي حكم الخليفتين عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر (300 –350هـ/912 –961م) بن عبد الرحمن الناصر (350-366هـ/961 –976م)
ادم متز، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ، ترجمة : محمد عبد الهادي ابو ريدة ، مج2 ، دار الكتاب العربي، بيروت ، ص338 .
ابن سيده ابو الحسن علي بن اسماعيل الاندلسي ، المخصص، مج2 ،بيروت ، ص162 .
صبري فارس الهيتي، نواعير الفرات شواهد تاريخية على اصالة حضارية، ندوة النواعير، مركز احياء التراث العلمي العربي، بغداد 1990، ص:15
المقري: أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب، شرح مريم قاسم طويل ويوسف علي طويل، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1، ج1، ص: 389.
[15]) الشـادوف: وهو من آلات الرفع الواطئ وهو عبارة عن عمود تتحرك فوقه خشبة طويلة يعلق في احد طرفيه الدلو ويثقل الطرف الاخر بالحجارة حتى اذا نزل الدلو في الماء وامتلأ صعد بقوة الثقل .
[16]) الري بالصهاريج : تعرف الصهاريج بأنها جوبة كالبئر المطوية بالبلاط نقرت من الصخور او هي حياض يجتمع الماء فيها. وتبنى الصهاريج في جوف الارض وتغطى فتحاتها بغطاء من الرخام . وتستخدم هذه الصهاريج للاستفادة من سيول الامطار وذلك من اجل خزنها عند الحاجة وتحفر هذه الصهاريج بالتدرج بحيث يكون الصهريج الاول اعلى مكاناً من الصهريج الثاني والتالي له والصهريج الثالث اقل ارتفاعاً من الثاني وهكذا. وفي مدينة قادس استخدمت صهاريج للسقي محكمة البناء وهي اعجب ما صنع على وجه الارض وكانت المياه تنصب في تلك الصهاريج فضلاً عن الخزانات والصهاريج في قصبة المرية . كما انشأ الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل (172-180هـ/788-796م ) الصهاريج الضخمة والبرك البديعة واحواض الرخام المزينة بتماثيل مختلفة. أحمد زكي: صهاريج عدن أروع أثار العرب في الهندسة، مجلة العربي، عدد 68، 1964، ص:57
[17]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1356
[18]) الخوارزمي ، محمد بن احمد بن يوسف ، مفاتيح العلوم ، مطبعة الشرق-مصر – 1342هـ ، ص46 .
[19] ) الكرخي ابو بكر محمد بن الحسن الحاسب ، انباط المياه الخفية ، حيدر اباد ، الدكن -1359 ، ص22- 23 .
[20] ) توماس ف.غليك، المرجع نفسه ، التكنولوجيا الهيدرولية ، ص1353 .
[21]) لاند ، روم ، الإسلام والعرب ، ترجمة : منير البعلبكي ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت-1977 ، ص:175 .
[22]) المقري ، نفح الطيب ، ج1 ، ص564 –565 .
[23]) فيليب حتي واخرون ، تاريخ العرب المطول ، ج3، ط2، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ، 1953 ، ص631 ؛ انيس زكريا النصولي، الدولة الاموية في قرطبة، ج1، المطبعة العصرية، بغداد – 1926، ص119 .
[24]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، التكنولوجيا الهيدرولية، ص1351
[25]) اونبة : قرية غرب الاندلس على خليج البحر المحيط. ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، ج1، دار صادر، 1397ه/1993م ص283
[26]) طركونة: مدينة حصينة على البحر المتوسط وبها رحى تطحن بقوة ماء البحر. مؤلف مجهول، ذكر بلاد الاندلس، دار أسامة- دمشق 1867م، ص:72
[27]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه ، التكنولوجيا الهيدرولية ، ص1354 – 1355 .
[28]) المقرى نفح الطيب، ج3، ص: 383
[29]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1357
[30]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1358
[31]) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة الاسلامية، الطبعة السابعة سنة1965 ج3، ص322
[32]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1361
[33]) احمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج1، المكتبة العلمية – بيروت ، ص: 118.
[34]) محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر– بيروت ط3– 1414 هـ،مج6، مادة حبس، ص45 .
[35] ) مقال بعنوان هندسة النوافير في الأندلس ، محمد هشام النعسان، نشر في 22-8-2016 في موقع قصة الإسلام www.ISLAMSTORY.COM اشراف الدكتور راغب السرجاني،
[36]) سعيد بنحمادة ، الماء والانسان في الأندلس في القرنين7و8هـ/13و14م ، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط1، 2007 (ص 103-104)،
[37]) سعيد بنحمادة ، المرجع نفسه، (ص 114).
[38]) حسين مؤنس، فجر الأندلس، دار العصر الحديث ، ودار المناهل، ط1، 1423ه /2002م، ص 602
[39]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1356
[40]) حسين مؤنس ، رحلة الأندلس حديث الفردوس الموعود، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط2، 1405ه/1985م، ص277
[41]) بعض المصادر التاريخية تشير الى أن تأسيسها يعود إلى عصر الحكم المستنصر ومن الممكن أن يكون مرد ذلك إلى أنه بدئ العمل بها في السنة الأخيرة من حكم أبيه الناصر أي 349هـ
[42]) فيصل دبدوب، بلنسية انظمة الري ومحكمة المياه فيها القائمة الى اليوم ، مجلة العربي ، ع 157 ، الكويت – 1971 ، ص129 .
[43]) محمد هشام النعسان، أساليب الري في بلنسيه الأندلسية، ندوة الإنتاج الصناعي والزراعي في الحضارة العربية الإسلامية، الجمعية الأردنية ، تاريخ العلوم ، الأردن- 2001 ، ص293 – 294 .
[44]) توماس ف.غليك، المرجع نفسه، ص: 1346
[45] ) ولد ابن جلجل عام 332 هـ، اهتم ابن جلجل بكتاب الحشائشلديوسقوريدس، فعمل على شرحه وتفسيره والتعليق عليه، وبخاصة على أسماء الأدوية وذلك في أكثر من مؤلف.
[46] ) ولد أبو المطرّف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن وافد بن مهند اللَّخْمِيّ المعروف بابن وافد في طليطلة في ذي الحجة 387 هـ. اهتم ابن وافد بدراسة الطب، وحذق علم الأدوية المفردة، وألف فيه كتابه «الأدوية المفردة» ولابن وافد كتب أخرى في الطب. وابن وافد يرى ضرورة تجنّب التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية، وإذا دعت الضرورة إلى التداوي بالأدوية فالأفضل التداوي بالأدوية البسيطة، وإذا كان لا بدّ من تركيب الأدوية فالأفضل عدم الإكثار وتوفي ابن وافد بعد سنة 460هـ.
[47] ) العالمالعربيالمسلمأبو بكر حامد بن سَمِجون، أو سَمْجون، طبيبأندلسي من أبناء القرن الرابع الهجري. كان له يد في تقدم العلوم الصيدلية والعقاقيرية في الأندلس أيام الحكم الثاني والحاجب المنصور بن أبي عامر. وقد توفي حوالي السنة 400 هـ. ولابن سمجون من الكتب: كتاب الأدوية المفردة وكتاب الأقراباذين.
[48] ) (القرن السادس الهجري / الثاني عشر ميلادي)
[49] ) أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله القرطبي (30 مارس1135 – 13 ديسمبر1204) المشهور بالرمبم (الحاخام موشيه بن ميمون) اشتهر بكونه أهم شخصية يهودية خلال العصور الوسطى وهو من عائلة يهودية شمال أفريقية من المغرب تُعرف بعائلة الباز وهي عائلة يهودية كبيرة
[50] ) ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي المَعروف بابن البيطار، والملقَّب بالنباتي والعشَّاب (593 هـ / 1197م – 646 هـ / 1248م) عالمنَبَاتيوصَيْدَليمُسلم، يعتبر من أعظم العلماء الذين ظهروا في القرون الوسطى، وعالم عصره في عُلوم النباتوالعَقَاقِير، والصيدلاني الأول في تراكيب الدَّواء ورائد العلاج الكيميائي. ولد في الأندلس بمدينة مالقة، وتلقى علومه في إشبيلية
[51]) إكسبيراثيون غارثيا سانشيز،الزراعة في إسبانيا، ترجمة أكرم ذا النون( بحث في كتاب الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس) ج2، ص: 1368-1369
[52]) فيصل دبدوب، بلنسية وانظمة الري ومحكمة المياه فيها القائمة الى اليوم ، مجلة العربي ، ع 157 ، الكويت – 1971 ، ص129 .
(4) محمد هشام النعسان، أساليب الري في بلنسيه الأندلسية، ندوة الإنتاج الصناعي والزراعي في الحضارة العربية الإسلامية، الجمعية الأردنية، تاريخ العلوم، الأردن-2001 ، ص293 – 294 .
[53]) أبو زكريا، يحيى بن محمد بن أحمد ابن العوام الأشبيلي،، كتاب الفلاحة، تقديم محمد الفايز، باريس مطبوعات الجنوب، ديسمبر2000، ص22
[54]) جورج سارطون، ابن بصال=كتاب الفلاحة، نشره وترجمه وعلق عليه خوسي ماريا مياس بيكروسا ومحمد عزيمان(231 صفة بالأسبانية و 182 صفحة بالعربية) تطوان، المغرب، معهد مولاي الحسن، 1955م. ترجمة مجلة تطوان لمقال الأستاذ جورج سارطون الأستاذ بجامعة هارفارد وهو تعليق صدر بمجلة”أسيس”(ISIS) مجلد 47 الصادر في مارس 1956م.ص: 74-77.
[55]) إكسبيراثيون غارثيا سانشيز، الزراعة في إسبانيا، ص: 1369
[56] )حسان حلاق، دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية، دار النهضة العربية-بيروت، ط2، 1999م، ص:284
[57]) خوان فيرنيه، العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية في الأندلس، ص: 1304
[58]) ابن وافد عبد الرحمن بن محمد، كتاب الأدوية المفردة منشورات محمد علي بيضون، دار الكبت العربية،2000، ص:9
[59])آنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية –القاهرة، ص: 475.
[60]) للتوسع أنظر كتاب سلمى الخضراء الجيوسي، الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس، مركز دراسات الوحدة العربية، ج2، ط2، 1999، الصفحات: 1345-1366 و1367-1384 و1385-1410.
[61] )
[62]) إبن بصال، كتاب الفلاحة، نشره وترجمه وعلق عليه: خوسي مارية مياس بييكروسا، ومحمد عزيمان معهد مولاي الحسن، تطوان 1955م.
[63]) محمد سويسي، نماذج من التراث العلمي العربي، دار الغرب الإسلامي، 2001 ص:208.